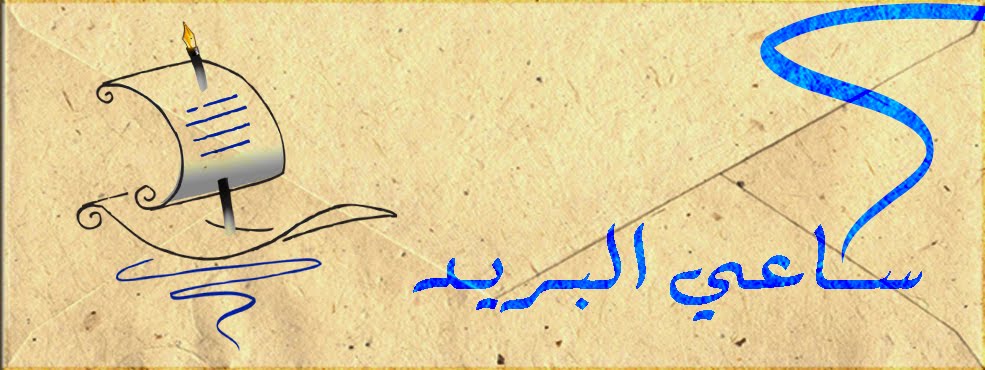بقلم عبد الله
العليان
قبل عدة أشهر نشر الأكاديمي والباحث الفلسطيني المعروف د. فهمي
جدعان، مذكراته الشخصية التي حملت عنوان "طائر التمّ.. حكايات جني الخُطا
والأيّام"، تحدث فيها عن طفولته، وعندما خرج مرغم هو وأسرته ومئات آلاف من
الفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم وحقولهم مجبرين بسبب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين،
بعد حرب عام 1948.
سرد فهمي جدعان في هذه المذكرات، قصة الهجرة من بلدته "عين
الغزال" بمدينة حيفا، إلى سوريا؛ التي احتضنت المهجرين الفلسطينيين قصرًا من
أرضهم بكل تقدير ورعاية، وتمت معاملتهم وكأنهم من الشعب السوري في جوانب عديدة من
الامتيازات، واستقر هو وأسرته في هذا المكان الذي أقاموا فيه في أحد أطراف مدينة
دمشق في الأربعينات، ثم أصبح اسم هذا المكان بعد عقد بعد ذلك بمسمى "مخيم
اليرموك" في خمسينات القرن الماضي.
درس فهمي جدعان في سوريا في مرحلة التعليم العام، حتى أنهى
الثانوية العامة، ووجد فرصة من إحدى المنظمات الإنسانية للابتعاث في فرنسا للدراسة
الجامعية في التاريخ، ثم واصل دراسته العليا أيضًا في فرنسا نفسها في إحدى أرقى الجامعات الفرنسية (السوربون)، في دراسة الفلسفة والفكر الإسلامي، وقد التقيت
بالدكتور فهمي جدعان على هامش المؤتمر التحضيري للقمة الثقافية العربية في بيروت
2010، وكنت أنا ود. عبيد الشقصي مشاركيْن في هذا المؤتمر، وقد جرى بيننا حديث طويل
حول بعض مؤلفاته وأرائه الأخرى الفكرية والفلسفية، والفترة التي قضاها في السلطنة،
أستاذًا جامعيًا، وعميدًا لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس.
وقال لي إنه قضى في السلطنة عدة سنوات، وهي سنوات من أفضل وأسعد
أيام حياته في عُمان مع أسرته، وبالأخص في مدينة مسقط، وكان انتقاله من السلطنة-
كما قال فهمي جدعان- بسبب بعض الظروف، ويُضيف: "تمنيتُ أن لا تكون حدثت
آنذاك، وكانت سببًا في تقديم استقالتي من جامعة السلطان قابوس، ولو أتيحت لي
الفرصة، لرجعت إلى عُمان مرة أخرى، وذلك لسعادتي بهذا البلد وأهلها، فعُمان بلد
يتمتع بأجواء تستطيع أن تشعر بالسعادة، لما تراه من هذا الشعب من احترام وتعامل
راق، وهذا ما جعلني، أسعد بالسنوات التي قضيتها في سلطنة عُمان حقيقة، وإن كانت
سنوات قليلة".
في مذكرات د. جدعان التي أشرت إليها آنفاً، تطرق إلى فترة عمله في
جامعة السلطان قابوس، وعلاقته بالعمل الأكاديمي، وعلاقاته الشخصية مع الأكاديميين
العُمانيين وغيرهم من الأكاديميين العرب في هذه الجامعة، الذين تعامل معهم وشعر
منهم الأخوة والألفة خلال تلك الفترة، وأعاد الحديث مرة أخرى عن تلك الأيام التي
لم يعشها في بلدان عربية أخرى، عمل فيها أستاذًا جامعيًا، ومما قاله فهمي جدعان عن
عُمان والعُمانيين في فترة إقامته: "إنني لم أشعر بأن البيت العُماني مقفل في
وجه المغتربين العاملين في السلطنة، مثلما قد لاحظت ذلك في- دولة أخرى- حيث يندر
أن تستقبل عائلة- من هذه الدولة- أحدًا من الوافدين في بيتها. أما هنا في السلطنة
فكانت البيوت مفتوحة مرحبة دون تحفظ، من أعلى القمة إلى أقراني في الكلية".
ويستعرض د. جدعان في هذه المذكرات أسماء الأشخاص من المسؤولين
والأكاديميين والشخصيات العامة التي كانت له علاقة وطيدة، ومع أنه كما قال قضى
عامين في هذه الجامعة، لكن ذاكرته تستحضر تلك الفترة، وكأنها سنوات طويلة، وقال
إنها:"أجمل سنوات عمري". بالقياس إلى الصداقات الكثيرة والرائعة التي
حصلت في عُمان.
ويستطرد د. فهمي جدعان تلك الأيام الذكريات الجميلة التي عاشها في
عُمان وكيف اتسمت بروح لا توصف من المحبة والمودة من العلاقة، فيقول :"فيها
عرفت النقاء والصدق والرعاية والوفاء والكرم والخصال الإنسانية الاستثنائية، التي
لم أعرفها في أي مكان آخر. في عُمان عرفت صداقات حقيقية غير عابرة، صداقات ترقى
إلى معاني الـ(فيليا) القديمة، صداقات تغمرها المحبة والمودة التي لا تعرف الخبث
والخداع والضغينة. حين أعاود النظر في هذا كله وأسأل نفسي لماذا تخليت عنه فجأة
وعدت إلى المكان الذي قدمت منه، يصيبني الذهول والمرارة والأسى، وأغضب من نفسي ولا
أغفر لها ما اقترفت من زلل".
ويذكر د. جدعان تلك الليلة التي أتى فيها من الأردن، لتقديم استقالته
من جامعة السلطان قابوس، للعمل في جامعة البتراء بالأردن، فيقول: "كان نهارًا
عصيبًا ذلك النهار الذي طلبت فيه مقابلة رئيس الجامعة- وكان آنذاك الدكتور سعود الريامي-
وتوجهت إلى مكتبه في إدارة الجامعة. وكان الحزن يتلبسني، والمرارة تملأ نفسي،
والشعور بالذنب بل بالخيانة وقلة الوفاء، يحتل كل كينونتي.. كنت أحسُ بأنني أغدر،
وبأنني أفعل ذلك للمرة الأولى في حياتي". وأشار د. فهمي جدعان في هذا اللقاء
مع رئيس الجامعة، إلى أنه طلب منه أن يبقى في عمله في الجامعة، وقال له الريامي:
"أنت هنا آمن ومرتاح والجامعة في حاجة ماسة إليك.. ولا أنصحك
بالاستقالة". وقال له: "لقد وعدتهم.. ولا يمكن أن أتراجع".
ويذكر فهمي جدعان هذا الموقف الصعب والمؤلم بعد إصراري على تقديم
استقالتي دون مُبرر وبتسرع غير معقول فيقول: "حين خرجت من مكتب الدكتور سعود الريامي
اندفعت من عينيّ دفقة من الدموع.. ومن نفسي موجة عاصفة من المرارة.. والفقد..
والتعلق.. إلى بلد أحببته إلى درجة العشق وظل دومًا يحتل جزءًا عزيزًا من روحي،
ومكانة خارقة في قلبي وفي وجداني".. وفي هذه المذكرات الكثير من الذكريات بين
السرد المؤلم، والأيام الرائعة، وهي قصة عمر مفكر ومؤلف اتسمت أفكاره بالجدية والحفر
المنهجي، قد نوافقه في بعضها وقد نختلف معه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية بتاريخ 29 يونيو 2021